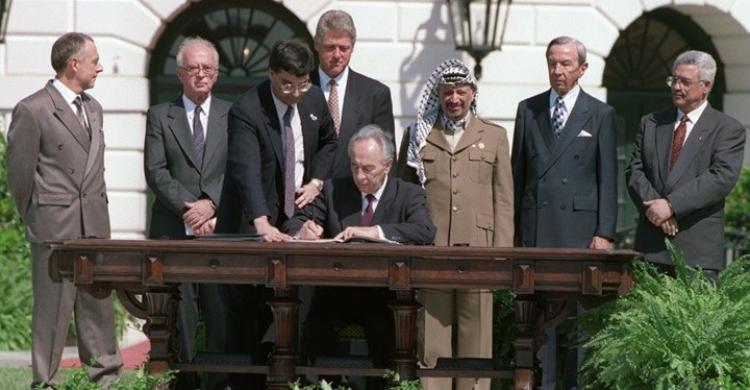بقلم/ محمد عبد الهادي
ثمة كثير من الملل والانزعاج تكبدته وأنا أشاهد فيلم "أوسلو"، الصادر في أيار/مايو 2021. على أن هذا الانزعاج لم يكن، في تقديري، راجعا لجرعة العنصرية الكامنة ضد الفلسطينيين، والمحاولات المستميتة لإظهار الفيلم؛ باعتباره عملا فنيا محايدا، بينما هو في الحقيقة يكاد يحتوي مقولات الصهيونية كلها.. لم يكن انزعاجي لهذه الأسباب فحسب، بل ثمة أسباب أخرى فنية بحتة، تجعل الفيلم شديد الركاكة.
أتصور أن من التبعات الفنية للعنصرية أن صانع العمل يجد نفسه منذ البداية مضطرا لافتعال واقع زائف ومنحاز لما تمليه عليه عنصريته، بغض النظر عن العلاقات الحقيقية بين البشر. هذا بالطبع يضرب العمل الفني في مقتل؛ لأنه يجبر صانع العمل على اختراع علاقات غير صادقة بدافع من الانحيازات الشخصية. لتوضيح ذلك، يمكنني تصور مخرج عنصري يصنع فيلما يصوّر البيض على أنهم الأخيار والسود على أنهم الأشرار. لن تكون المشكلة هنا أخلاقية فقط، بل ستكون في مدى افتعال تلك العلاقة بين البشر؛ لأننا جميعا نعلم أن بين هؤلاء وأولئك أخيار وأشرار. لذلك حين تطغى السياسة على الفن يصبح العمل الفني مملا، ركيكا، حتى لو وافق هوانا السياسي؛ لأن الغاية الطيبة لا تبرر رداءة العمل فنيا. لذلك أيضا خلدت الأعمال التي تسخر من الديكتاتورية وفي الوقت ذاته تستوفي معايير الجمال الفني.
هذا المدخل ضروري برأيي حتى أوضح موقفي من فيلم أوسلو.
منذ بدايته، وقع فيلم أوسلو في هذا النوع من الفخاخ؛ فخاخ التنميط العنصري الذي يعجز تماما عن رؤية الحقيقة الواقعية. منذ البداية بتصوير الاضطرابات السياسية والانتفاضة الفلسطينية على أنها أعمال عنف متبادل بين "نديْن" أو شعبين متكافئين في القوة والعنف. منذ اللحظة الأولى تسود لغة الخطاب الكاذب، الذي يروج لفكرة أننا شعبان متحاربان، غارقان في صراع ينتمي إلى الماضي، فلماذا لا ننظر إلى المستقبل بعين الأمل والتعاون والمحبة؟ وهو السؤال الذي يعجبني لو لم يسأله ذلك الصهيوني الذي وقف يقول لجارته الفلسطينية: إذا لم أسرق بيتك، سيأتي غيري ويسرقه.
سيكون هذا السؤال البريء مفعما بالأمل حقا لو أن الذين يطرحونه لا يبنون رؤيتهم للتعايش على كون البشر مختلفين باختلاف أديانهم، بحيث يكون للصهيوني حق في انتزاع بيت من بيوت الشيخ جراح، لمجرد أن مالكه عربي مسلم أو مسيحي حتى، ولمجرد أن سارقه يهودي صهيوني. لقد طرح مثقفون فلسطينيون مخلصون (محمود درويش مثلا) طروحات كثيرة تبحث عن نوع من التعايش الذي لا بد منه لإيقاف نزيف الدم، شريطة أن يبدأ من نقطة راسخة: بشر متساوون في الحقوق والواجبات، لا يمكن انتهاك حقوقهم الأساسية، فهل قبلت إسرائيل بأي طرح من هذا القبيل؟
هل قبلت إسرائيل بأي طرح من هذا القبيل؟
من المفارقات المضحكة في الفيلم، أنه لا يرى شيئا من الواقع، بل يتصور واقعا مفتعلا حد الإضحاك، مثلما يروج العنصريون البيض مثلا عن السود بأنهم مجرد وحوش مجرمة.. رغم أنهم يعيشون معهم على الأرض ذاتها. هكذا تختلق العنصرية علاقات وهمية وتصدقها. مثلا: حين يعرف وزير مالية منظمة التحرير الفلسطينية "أحمد قريع" بأنه سيلتقي بأستاذ اقتصاد إسرائيلي، يضطرب، يقول بأنه لم يلتق بإسرائيلي من قبل.
وحين يلتقي به، ويحرك الإسرائيلي يده في أثناء الكلام، يتراجع قريع مضطربا كأن محدثه سيقتله مثلا! لماذا لا يعلم صناع الفيلم أن الفلسطيني العادي يلتقي بإسرائيليين كثيرين لأنهم محتلو أرضه؛ يلتقيهم عند المعابر وفي نقاط التفتيش، والمباني الحكومية، والمطارات وغيرها، دون أن يرتعب الفلسطيني ويتراجع "مخضوضا" لأن يد رجل إسرائيلي تحركت أمامه! هذا بالتحديد ما أزعجني منذ البداية: كيف يصنع أحد فيلما عن فلسطين دون أن يعرف المعلومات البديهية والمعطيات اليومية في حياتهم؟
بالطبع، يتذاكى صناع الفيلم، يتصورون أنه من الممكن إقناع العالم أن الفلسطينيين مجرد همج منحطين، كلما اختلف مفاوض فلسطيني مع نظيره الإسرائيلي زعق فيه. وحين تناول مفاوض إسرائيلي عرفات بمزاح خفيف، هاج المفاوض الفلسطيني وأصر على ضربه! أما آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا، ويُقتلون، على الهوية، فلا نكاد نرى منهم أحدا في الفيلم. حتى لحظة مقتل فتى فلسطيني (لأنه يعتدي على جنود الاحتلال) حتى تلك اللحظة، لا يعرضها المخرج إلا بعيني جندي صهيوني رقيق القلب، ينظر بذهول نحو مكان سقوط الشهيد الفلسطيني، الذي لا تظهر جثته حتى، وبلا قطرة دم واحدة على شاشة المشهد!
يقسم الفيلم البشر إلى الأنواع التي يحبها ويكرهها
كما أن "حسن" مساعد المفاوض الفلسطيني، الشيوعي، رجل متجهم ذو شارب ثقيل وبنيان ضخم، حاد الملامح، سليط اللسان، عدواني، يقابله مساعد المفاوض الإسرائيلي، المبتسم دوما، طيب الملامح، سريع البديهة، والأهم: دائم التحمل لاعتداءات نظرائه الفلسطينيين الأوغاد. هكذا إذن!
في الفيلم اعتمد الكاتب والمخرج حيلا ضعيفة فنيا لإثارة مشاعر المشاهد. منها مثلا كثرة الزعيق وشدته، بلا مبرر، بالإضافة إلى قدر غريب من النظرات المصطنعة، التي تبدو نوعا من "الميكب" أكثر من كونها نظرات طبيعية للبشر. ثمة دراما أخرى تحاول خلق توتر بشكل غير مقنع. مثلا: يعرقل المفاوض الفلسطيني المفاوضات، فيخرج المفاوض الإسرائيلي غاضبا، ليجد حلا سحريا: يصطحب صاحب البيت وزوجته للرقص في مرآب البيت لتهدئة أعصابه، ثم يعود للمفاوضات متحملا سخافة هذين الفلسطينيين. أرأيت إذن كم هم إنسانيون ومحبون للفن هؤلاء الصهاينة؟!
من مظاهر ابتعاد الفيلم عن وقائع الحياة، واعتماده نهجا تنميطيا يقسم البشر إلى الأنواع التي يحبها ويكرهها، بناء مشهد كامل على حوار بين مفاوض فلسطيني وصهيوني، بحيث ينتهي الحوار إلى مصادفة مدهشة: كلاهما لديه طفلة اسمها مايا؛ هكذا يكتشفان في ذروة درامية مضحكة كيف أنهما شعب واحد ينبغي أن يعيش في سلام، أليس لابنتيْهما الاسم ذاته؟ أما الفارق الهائل في توزيع حقوق المواطنة بينهما، وأما حرمان أحدهما من كل شيء تقريبا ومنح الآخر كل شيء.. فهذا يبدو لصناع الفيلم أمرا هامشيا، لا نحتاجه في وقت تصفية الأجواء وفتح صفحة السلام الجديدة.
هذا الفيلم، بتقديري، نوع من البروباجندا الصهيونية، كما أنه ضعيف فني، مليء بالزعيق والنظرات المتشنجة، والمضحكة في آن معا!